يعارض الواقع إرادته؛ أي عندما تسير الأمور على عكس ما يأمل أو يشتهي!
كأن يفاجأ على سبيل المثال بتصرف إنسان آخرء تربطه به علاقة صداقة
راسخة أو حب أو زواج؛ تصرف لم يكن يتوقع صدوره عن هذا الإنسان
تحديداً ولا بحال من الأحوال؛ أو كأن يقوم أحد الزملاء أو الرؤساء في العمل
بفعل محرج أو مزعج يفوق ما يمكن أن يتوقعه من ذلك الشخص بالذات.
"خبرتي" ومعرفتي بالناس وبكيفية التعامل معهم؟ وهل يُعقل أن يكون منطق
ولكن كلما تمعن المرء في التفكير بالأمرء اقترب من النظر إلى حالات
الصراع هذه؛ أي حالات الاختلاف بين ما هو متوقع وما يحدث فعلاًء من
المنظار السليم وترسخت القناعة لديه بأن "الصراع" هو من أهم الأمور في
الحياة وأكثرها عطاءً وثمرآء لا بسبب عدم إمكانية تجنبه فحسب» وإنما لأنه
من الأسباب الحيوية والجوهرية لنمو وتطور الشخصية البشرية. فما الحياة
عندما تسير كل الأمور على ما يرام في غياب حالات الصراع التي تعاكس
اكتشاف طبائع الناس وطرق التعامل معهم
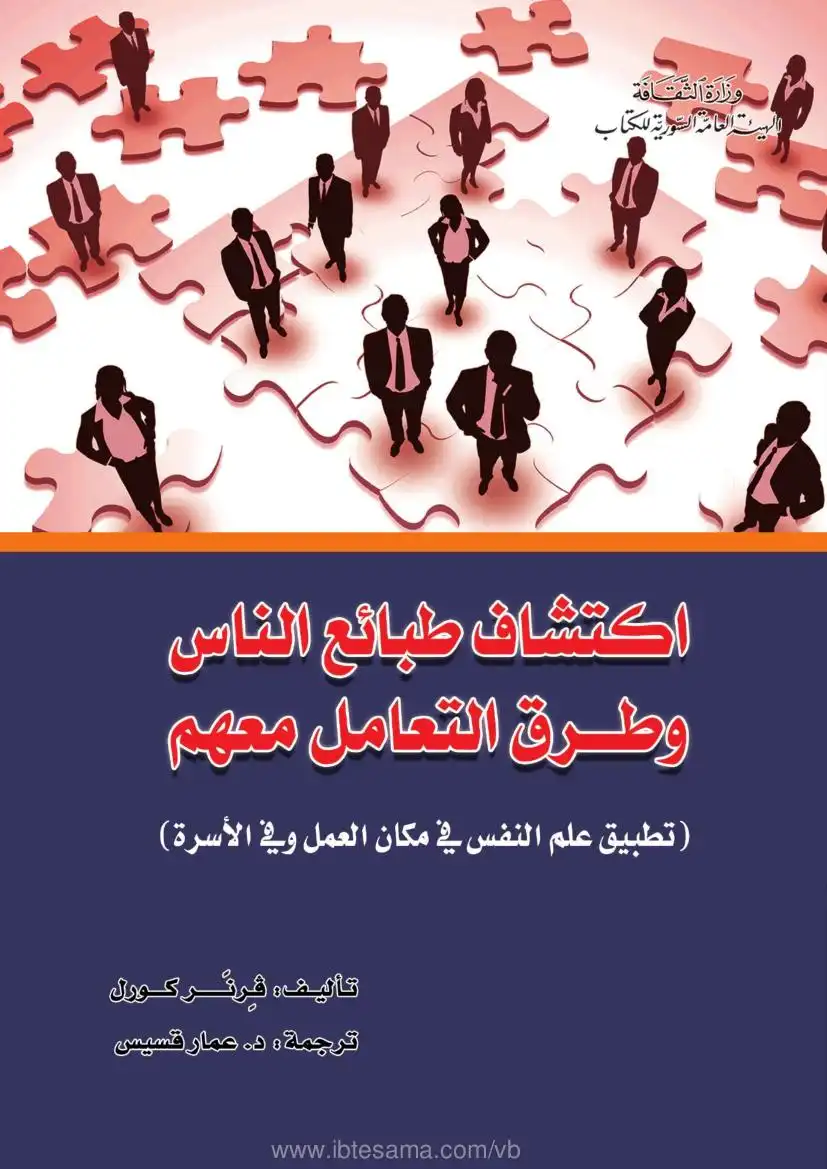
الوصف
اكتشاف طبائع الناس وطرق التعامل معهم لـ فرنر كوول ، إن معرفة الذات وتحديد القدرات الذاتية تحديداً موضوعياً يجب أن يعتمد على الإختبارات السيكولوجية المعيارية المعروفة التي ذكرناها في الكتاب ، والتي لا تقتصر بالطبع على اختبارات تحديد حاصل الذكاء ، وبناء على التحديد الموضوعي للقدرات يجب أن توضع خطة الحياة وأن يتم اختيار العمل المناسب والهوايات والنشاطات الترفيهية ، وهنا يتساوى في الخطأ التواضع الزائف والمبالغة في تقدير القدرات الذاتية .
استعادة نشاطنا وحيويتنا. وما دامت الأمور تسير على ما يرام؛ يتصرف
المرء ببساطة دون أن يشعر بالحاجة للتغيّر أو التطوّر ولا يبدأ بالتفكير
وبوسع المرء توفير متاعب الخوض في الكثير من طرق الحل عديمة
الجدوى عندما ينظر إلى تلك الأمور والظروف» التي تسبب له المتاعبء عبر
منظار علم_النفس وعندما يستفيد من الحقائق والخبرات والمدركات
المستخلصة في هذا المجال.
سنحاول في الفصل الأول من هذا الكتاب مناقشة مسألة وجود حالات
الصراع التي لا يمكن تجنبهاء والتي قد تكون من أهم الأمور في الحياة
وأكثرها عطاء وثمراً؛ برغم كل مشاعر الانزعاج التي تسببها. كيف تنشاً
حالات الصراع؟ وكيف على الإنسان أن يتصرف في تلك الحالات؛ وما الذي
عليه أن يتجنبه؟ ما هو الأثر الذي تتركه حالات الصراع التي لا تقبل الحل؟
وهل من إمكانيات لتجنب الدخول في حالات الصراع إلى حد بعيدء أو
من الكتابء وسنتابع مناقشة بعض الأفكار والطروحات ذات الصلة في
المرء ببساطة دون أن يشعر بالحاجة للتغيّر أو التطوّر ولا يبدأ بالتفكير
وبوسع المرء توفير متاعب الخوض في الكثير من طرق الحل عديمة
الجدوى عندما ينظر إلى تلك الأمور والظروف» التي تسبب له المتاعبء عبر
منظار علم_النفس وعندما يستفيد من الحقائق والخبرات والمدركات
المستخلصة في هذا المجال.
سنحاول في الفصل الأول من هذا الكتاب مناقشة مسألة وجود حالات
الصراع التي لا يمكن تجنبهاء والتي قد تكون من أهم الأمور في الحياة
وأكثرها عطاء وثمراً؛ برغم كل مشاعر الانزعاج التي تسببها. كيف تنشاً
حالات الصراع؟ وكيف على الإنسان أن يتصرف في تلك الحالات؛ وما الذي
عليه أن يتجنبه؟ ما هو الأثر الذي تتركه حالات الصراع التي لا تقبل الحل؟
وهل من إمكانيات لتجنب الدخول في حالات الصراع إلى حد بعيدء أو
من الكتابء وسنتابع مناقشة بعض الأفكار والطروحات ذات الصلة في
]1. ظاهرة «الصراع»
١ - الصراع مشكلة العصر!
مكان العمل - مع رب العمل أو مع العاملين والزملاء أو مع العملاء
والزبائن - أم كان
والقوانين والبيروقراطية - أم كان ذلك في مجال الحياة الشخصية - مع
الأطفال أو مع أقرب وأعز الناس كالصديق أو الحبيب! ولكل تلك الحالات
صفة مشتركة وهي أن حالة الصراع تنشأً عندما نتوقع أمراً ما ولا يتحقق -
نا في تكويننا كائنات تأمل وترغب وتتوقع وتنظر باستمرار إلى المستقبل»
ولما كنا لا نستطيع أن نملك زمام كل الأمورء فإن احتمال الإخفاق الكلي أو
عدم تحقيق الآمال أو التطلعات يسمى إحباطاً «دثاة»اهن0 لأن الجهود المبذولة
والآمال المربوطة بتحقيق الأهداف تكون قد ذهبت سدى (حسب التعبير
فالتطلعات هي "أهداف" تحكم تصرفاتنا إلى أبعد الحدود. والإنسان
ذلك في خضم تسيير الأمور الحياتية - مع الأنظمة
بطبيعته لا يستطيع أن يعيش بلا هدف في الحياة؛ لأن غياب الأهداف يصيب
١ - الصراع مشكلة العصر!
مكان العمل - مع رب العمل أو مع العاملين والزملاء أو مع العملاء
والزبائن - أم كان
والقوانين والبيروقراطية - أم كان ذلك في مجال الحياة الشخصية - مع
الأطفال أو مع أقرب وأعز الناس كالصديق أو الحبيب! ولكل تلك الحالات
صفة مشتركة وهي أن حالة الصراع تنشأً عندما نتوقع أمراً ما ولا يتحقق -
نا في تكويننا كائنات تأمل وترغب وتتوقع وتنظر باستمرار إلى المستقبل»
ولما كنا لا نستطيع أن نملك زمام كل الأمورء فإن احتمال الإخفاق الكلي أو
عدم تحقيق الآمال أو التطلعات يسمى إحباطاً «دثاة»اهن0 لأن الجهود المبذولة
والآمال المربوطة بتحقيق الأهداف تكون قد ذهبت سدى (حسب التعبير
فالتطلعات هي "أهداف" تحكم تصرفاتنا إلى أبعد الحدود. والإنسان
ذلك في خضم تسيير الأمور الحياتية - مع الأنظمة
بطبيعته لا يستطيع أن يعيش بلا هدف في الحياة؛ لأن غياب الأهداف يصيب
المرء بالكآبة التي قد تودي به إلى الانتحار. ومن ناحية أخرى فإن تحقيق
الهدف يجعل الإنسان "يعيش" النجاح ويكسبه "خبرة النجاح"؛ وحالات النجاح
الجسدي فحسب؛ بل قد تأخذ الفاعلية طابعاً فكرياً بحتاً. وهكذا يسعى الإنسان
في نهاية المطاف دائماً إلى النجاح؛ أي إلى تحقيق أهدافه. وكلما استطاع أن
راسخة بأهمية وجدوى ومشروعية تلك الأهداف؛ سَهُلَ تحقيقها. وفي هذه
الحال نتكلم عن قيام رابطة قوية - اتّحاد - بين الهدف وصاحبه. ولا شك أن
الإخفاق سيكون حتمياً في غياب تلك الرابطة القويةء أي عندما لا يستطيع
صاحب الهدف
القناعة_ التامة بإمكانية تحقيقه؛ أم بسبب عدم _الاقتناع بمشروعيته أو
بمشروعية أي من مكونات ذلك الاتحاد بينه وبين هدفه. ولسوء الحظ فإن
967 من العاملين في ألمانيا على سبيل المثال تنقصهم تلك الرابطة القوية
تنافر فكري بين رغبات العامل الداخلية وما يقوم به مهنياً. إنه لا يقوم بعمله
لتحقيق ذاته أو انطلاقاً من دافع أولي داخلي؛ بل انطلاقاً من دوافع ثانوية نحو
إرضاء الرئيس في العمل أو تحقيق شروط الترفيع الوظيفي أو ببساطة
بغرض كسب المال للعيش. وهنا سرعان ما ينتقل الهدف الحقيقرٍ ان في
الحياة إلى مجالات تقع خارج نطاق العمل مثل نشاطات أوقات الفراغ كالقيام
بالرحلات وممارسة الهوايات المختلفة. وهكذا ينتقل اهتمام معظم الناس من
مجال عملهم إلى مجالات الحياة خارج نطاق العمل حيث تزداد توقعاتهم
بالتجاح في تلك المجالات؛ بينما ينمو لديهم شعور بالإحباط وعدم الاكتراث
في مجال الحياة المهنية وتصبح نشاطاتهم في هذا المجال المهم والحيوي
الهدف يجعل الإنسان "يعيش" النجاح ويكسبه "خبرة النجاح"؛ وحالات النجاح
الجسدي فحسب؛ بل قد تأخذ الفاعلية طابعاً فكرياً بحتاً. وهكذا يسعى الإنسان
في نهاية المطاف دائماً إلى النجاح؛ أي إلى تحقيق أهدافه. وكلما استطاع أن
راسخة بأهمية وجدوى ومشروعية تلك الأهداف؛ سَهُلَ تحقيقها. وفي هذه
الحال نتكلم عن قيام رابطة قوية - اتّحاد - بين الهدف وصاحبه. ولا شك أن
الإخفاق سيكون حتمياً في غياب تلك الرابطة القويةء أي عندما لا يستطيع
صاحب الهدف
القناعة_ التامة بإمكانية تحقيقه؛ أم بسبب عدم _الاقتناع بمشروعيته أو
بمشروعية أي من مكونات ذلك الاتحاد بينه وبين هدفه. ولسوء الحظ فإن
967 من العاملين في ألمانيا على سبيل المثال تنقصهم تلك الرابطة القوية
تنافر فكري بين رغبات العامل الداخلية وما يقوم به مهنياً. إنه لا يقوم بعمله
لتحقيق ذاته أو انطلاقاً من دافع أولي داخلي؛ بل انطلاقاً من دوافع ثانوية نحو
إرضاء الرئيس في العمل أو تحقيق شروط الترفيع الوظيفي أو ببساطة
بغرض كسب المال للعيش. وهنا سرعان ما ينتقل الهدف الحقيقرٍ ان في
الحياة إلى مجالات تقع خارج نطاق العمل مثل نشاطات أوقات الفراغ كالقيام
بالرحلات وممارسة الهوايات المختلفة. وهكذا ينتقل اهتمام معظم الناس من
مجال عملهم إلى مجالات الحياة خارج نطاق العمل حيث تزداد توقعاتهم
بالتجاح في تلك المجالات؛ بينما ينمو لديهم شعور بالإحباط وعدم الاكتراث
في مجال الحياة المهنية وتصبح نشاطاتهم في هذا المجال المهم والحيوي
مجرد وسيلة لتحقيق رغبات أخرى بعيدة عنه. ولا تقتصر صحة هذا التصور
على العامل في مكان عمله فحسب» بل يبقى هذا التصور صحيحاً أيضاً
بالنسبة للعلاقة بين التلميذ ومواده الدراسية في المدرسة من جهة والطالب
ونغير هذه الصورة القاتمة عندما نتعلم كيف نفهم أنفسنا فهماً صحيحاً وكيت
نتعامل مع من حولنا في المجتمع من زملاء وشركاء وأطفال ومواطنين بشكل
وهنا نود الإشارة إلى ملاحظة مهمة جداً ومثيرة فعلاً للاهتمام وهي أن
الملفت أن مستوى توقعاتنا وآمالنا يرتفع باطراد مع تحسّن أحوالنا بشكل عام!
وهذا ربما يناقض الافتراض القائل بأن المرء سيكون أكثر رضا وقناعة بعد
أن تتحقق معظم آماله الحالية. على العكس من ذلك. فإننا نرى في الواقع أن
الروحي والنفسي ككل يعتمد في الأساس على أن آمالنا وتوقعاتنا تتجدد
باستمرار ويرتفع مستواها. فاستقلالنا المضطرد عن وصاية الآخرين
وتحررنا من كل ما يحدد حريثنا ويثقل كاهلنا يجعلنا أكثر نضجاً وبلوغاً
ويجعلنا نسعى إلى المزيد من تحقيق الذات ويجعلنا علاوة على ذلك نطالب
بحريتنا وتحقيق ذاتنا من موقع القوة!
لقد كان أسلافنا عموماً أكثر منا رضا واتزاناً برغم - وربما بسبب -
ظروفهم المعيشية الصعبة! فحياتهم كانت مليئة بالإخفاقات ولم يكن الحظ
يحالفهم أكثر مما يحالفنا. ولكنهم برغم ذلك كانوا أكثر منا قدرة على تحمل
الإخفاقات والظروف الصعبة؛ ربما لأنهم كانوا يردونها إلى أسباب دينية
قية؛ ولأنهم كانوا يؤمنون أكثر منا "بالقضاء والقدر". وربما كانوا
وإرادة
على العامل في مكان عمله فحسب» بل يبقى هذا التصور صحيحاً أيضاً
بالنسبة للعلاقة بين التلميذ ومواده الدراسية في المدرسة من جهة والطالب
ونغير هذه الصورة القاتمة عندما نتعلم كيف نفهم أنفسنا فهماً صحيحاً وكيت
نتعامل مع من حولنا في المجتمع من زملاء وشركاء وأطفال ومواطنين بشكل
وهنا نود الإشارة إلى ملاحظة مهمة جداً ومثيرة فعلاً للاهتمام وهي أن
الملفت أن مستوى توقعاتنا وآمالنا يرتفع باطراد مع تحسّن أحوالنا بشكل عام!
وهذا ربما يناقض الافتراض القائل بأن المرء سيكون أكثر رضا وقناعة بعد
أن تتحقق معظم آماله الحالية. على العكس من ذلك. فإننا نرى في الواقع أن
الروحي والنفسي ككل يعتمد في الأساس على أن آمالنا وتوقعاتنا تتجدد
باستمرار ويرتفع مستواها. فاستقلالنا المضطرد عن وصاية الآخرين
وتحررنا من كل ما يحدد حريثنا ويثقل كاهلنا يجعلنا أكثر نضجاً وبلوغاً
ويجعلنا نسعى إلى المزيد من تحقيق الذات ويجعلنا علاوة على ذلك نطالب
بحريتنا وتحقيق ذاتنا من موقع القوة!
لقد كان أسلافنا عموماً أكثر منا رضا واتزاناً برغم - وربما بسبب -
ظروفهم المعيشية الصعبة! فحياتهم كانت مليئة بالإخفاقات ولم يكن الحظ
يحالفهم أكثر مما يحالفنا. ولكنهم برغم ذلك كانوا أكثر منا قدرة على تحمل
الإخفاقات والظروف الصعبة؛ ربما لأنهم كانوا يردونها إلى أسباب دينية
قية؛ ولأنهم كانوا يؤمنون أكثر منا "بالقضاء والقدر". وربما كانوا
وإرادة
بالتقبل والصبر ونجحوا في "امتحان الحياة".
اعتدنا ألا نقبل بالهزائم ببساطة وألا ننظر إلى الصراع على أنه أمر مفروض
علينا ولا يمكننا تجنبه. بل لقد تعلمنا أن نحلل حالات الصراع ونستخلص
أسبابها ونحاول حلها أو تفادي الوقوع فيها في المستقبل. وفي جميع الأحوال
ومستقلين يحتم علينا أن نكون قادرين على السيطرة على حياتنا وعلى "التحكم
بقدرنا" إلى حد ما. كما نعتقد أن بوسعنا فعل الكثير من أجل تحقيق سعادثتا -
بدل القبول بأن كل شيء مرسوم مسبقاً وأن ليس باليد حيلة! فمن وجهة النظر
وهكذا لقد حملنا في عصرنا الحديث فكرة التحرر أو الحرية هذه إلى
معظم مجالات الحياة. فحركة تحرر النساء من هيمنة الرجال والأزواج قد
بدأت فعلاً؛ ولم تعد صلة الزوجين تعني الالتصاق المطلق والتبعية الكلية
والالتزام الكامل بالانتماء الكلي والحصري للرابطة الزوجية؛ ولم يعد التلاميذ
والطلاب ملتزمين بالاحترام المطلق تجاه المعلمين أو بتنفيذ "أوامرهم؛ وهو
ما كان جزءاً من التقاليد والأعراف المتبعة لدى أجدادنا. وفي مجال الحياة
المهنية لم يعد العامل يرضى بالعلاقة التي كانت سائدة فيما سبق مع رب
العمل فهو لم يعد يشعر بأن من البديهي أن ينفذ أوامر رب العمل وأن يقوم
بما هو مطلوب منه دون حق الاعتراض. إن العامل في وقتنا الراهن أصبح
يظالب بالمشاركة في ضبنع القُران ويحقه في اتحقيق ذاته:من بخلال عمله ولم
يعد يرضى في كثير من الأحيان بأن يقوم بعمله بغرض الحصول على الأجر
فحسب؛ بل إنه يسعى إلى ممارسة عمله انطلاقاً من دافع أولي داخلي لديه.
اعتدنا ألا نقبل بالهزائم ببساطة وألا ننظر إلى الصراع على أنه أمر مفروض
علينا ولا يمكننا تجنبه. بل لقد تعلمنا أن نحلل حالات الصراع ونستخلص
أسبابها ونحاول حلها أو تفادي الوقوع فيها في المستقبل. وفي جميع الأحوال
ومستقلين يحتم علينا أن نكون قادرين على السيطرة على حياتنا وعلى "التحكم
بقدرنا" إلى حد ما. كما نعتقد أن بوسعنا فعل الكثير من أجل تحقيق سعادثتا -
بدل القبول بأن كل شيء مرسوم مسبقاً وأن ليس باليد حيلة! فمن وجهة النظر
وهكذا لقد حملنا في عصرنا الحديث فكرة التحرر أو الحرية هذه إلى
معظم مجالات الحياة. فحركة تحرر النساء من هيمنة الرجال والأزواج قد
بدأت فعلاً؛ ولم تعد صلة الزوجين تعني الالتصاق المطلق والتبعية الكلية
والالتزام الكامل بالانتماء الكلي والحصري للرابطة الزوجية؛ ولم يعد التلاميذ
والطلاب ملتزمين بالاحترام المطلق تجاه المعلمين أو بتنفيذ "أوامرهم؛ وهو
ما كان جزءاً من التقاليد والأعراف المتبعة لدى أجدادنا. وفي مجال الحياة
المهنية لم يعد العامل يرضى بالعلاقة التي كانت سائدة فيما سبق مع رب
العمل فهو لم يعد يشعر بأن من البديهي أن ينفذ أوامر رب العمل وأن يقوم
بما هو مطلوب منه دون حق الاعتراض. إن العامل في وقتنا الراهن أصبح
يظالب بالمشاركة في ضبنع القُران ويحقه في اتحقيق ذاته:من بخلال عمله ولم
يعد يرضى في كثير من الأحيان بأن يقوم بعمله بغرض الحصول على الأجر
فحسب؛ بل إنه يسعى إلى ممارسة عمله انطلاقاً من دافع أولي داخلي لديه.
ولما كانت تطلعات وآمال جميع الناس تتزايد وتكبرء فإن الصدام حتمي
"التوسع الذاتي" وتحقيق طموحاته المتزايدة؛ بل إن لجميع من حولنا المسعى
ذاته. وإذا ما فرضنا إرادتنا في أمر ماء فإننا نكون قد أجبرنا الآخرين على
القبول بإرادة غريبة عنهم. وبالمقابل فإن تحقيق الآخرين لإرادتهم تعني أن
الأطراف يعني في الوقت ذاته إحباطاً لطرف آخرء مما يجعل اتساع استقلال
وتحرر الفرد في المجتمع مرهوناً بثمن باهظ من الإحباط. ويرتفع ذلك الثمن
بازدياد مساحة الاحتكاك بين الأشخاص أي بازدياد الكثافة السكانية في مكان
ما. ولا شك أن تقنيات الاتصالات الحديثة تزيد أيضاً من مساحة الاحتكاك
بين الأشخاص مهما كانت أماكن تواجدهم الجغرافي متباعدة.
الإحباط تنخفض باستمرارء بينما يزداد في الوقت ذاته خطر تعرضنا له.
وهذا ما يعني أن احتمال وقوعنا في حالات الصراع يتزايد باطراد دون أن
نكون "مسلحين" بما يساعدنا على حل تلك الحالات أو التغلب على أسباب
وجود الصراع أصلاً لأننا لم نعد قادرين على رؤية وفهم الواقع وتقبل
؟ - الإحباط أحد أهم أسباب العذف
الصراع - هو العنف أو على الأقل الميل إلى العنف بهدف إلحاق الضرر
بمنبع أو مسبب الصراع أو القضاء عليه! إلا أن البشرية ومنذ آلاف السنين
"التوسع الذاتي" وتحقيق طموحاته المتزايدة؛ بل إن لجميع من حولنا المسعى
ذاته. وإذا ما فرضنا إرادتنا في أمر ماء فإننا نكون قد أجبرنا الآخرين على
القبول بإرادة غريبة عنهم. وبالمقابل فإن تحقيق الآخرين لإرادتهم تعني أن
الأطراف يعني في الوقت ذاته إحباطاً لطرف آخرء مما يجعل اتساع استقلال
وتحرر الفرد في المجتمع مرهوناً بثمن باهظ من الإحباط. ويرتفع ذلك الثمن
بازدياد مساحة الاحتكاك بين الأشخاص أي بازدياد الكثافة السكانية في مكان
ما. ولا شك أن تقنيات الاتصالات الحديثة تزيد أيضاً من مساحة الاحتكاك
بين الأشخاص مهما كانت أماكن تواجدهم الجغرافي متباعدة.
الإحباط تنخفض باستمرارء بينما يزداد في الوقت ذاته خطر تعرضنا له.
وهذا ما يعني أن احتمال وقوعنا في حالات الصراع يتزايد باطراد دون أن
نكون "مسلحين" بما يساعدنا على حل تلك الحالات أو التغلب على أسباب
وجود الصراع أصلاً لأننا لم نعد قادرين على رؤية وفهم الواقع وتقبل
؟ - الإحباط أحد أهم أسباب العذف
الصراع - هو العنف أو على الأقل الميل إلى العنف بهدف إلحاق الضرر
بمنبع أو مسبب الصراع أو القضاء عليه! إلا أن البشرية ومنذ آلاف السنين
كانت وما تزال تسعى جاهدة إلى كبح ذلك الميل الفطري الخطير إلى العنف
من خلال وضعه ضمن أشد المحرمات. .وما تحريم العنف في جميع
الحضارات وعبر كل العصور إلا دلالة واضحة على الخطر العام والكبير
الذي يشكله انتشار ثقافة العنف على استمرار البشرية برمتها.
ولقد استطاعت بعض "المنافا" القليلة أن تحتفظ لنفسها باستثناء من
تحريم إظهال العنف وقي المآلاك *الأصطرارية فق تذكر متها على بتبيل
المثال الرياضة بشكليها الفعال أو السلبي أي من خلال ممارسة الرياضة أو
بمجرد الاكتفاء بمتابعة المبارزات الرياضية والتعاطف مع أحد الأطراف
السلبي؛ فإنه يستطيع أن يفرغ العنف المحتقن داخله دون خطر بالمقدار الذي
يستطيع به التعاطف أو الاتحاد مع منفذ الحركات العنيفة بشكلها الرياضي. إذ
هو ذاته. وبوسعنا أن نلاحظ بسهولة أن القواعد التي تحكم المبارزات
الرياضية تزداد وتتعقد بالمقدار الذي يزداد فيه عدد المشاركين في الحدث
الرياضي ككل! وهذا ما يسبب بدوره الإحباط والعنف من جديد لأن تلك
القواعد تقيد المتبارزين والمتابعين على حد سواء وتسلبهم حريتهم في التعبير
تجري في عطلة نهاية الأسبوع: فلقد أصبح العنف الفعلي الظاهر بين مشجعي
الفريقين مشهدا مألوفا بعد انتهاء المباريات - وأحيانا أثناءها! وفي الواقع
ليس لدينا أية "لعبة"' رياضية تسمح قواعدها بإظهار العنف بشكل صريح
أو "صمام" أمان للعنف المحتقن في داخلناء ولكنه يبقى مجرد منفذ صغير غير
قادر على احتواء كل العنف المتزايد المحتقن فينا .
وكيف نحكم على مشاهد العنف التي تتسابق أمام أعين المشاهدين على
من خلال وضعه ضمن أشد المحرمات. .وما تحريم العنف في جميع
الحضارات وعبر كل العصور إلا دلالة واضحة على الخطر العام والكبير
الذي يشكله انتشار ثقافة العنف على استمرار البشرية برمتها.
ولقد استطاعت بعض "المنافا" القليلة أن تحتفظ لنفسها باستثناء من
تحريم إظهال العنف وقي المآلاك *الأصطرارية فق تذكر متها على بتبيل
المثال الرياضة بشكليها الفعال أو السلبي أي من خلال ممارسة الرياضة أو
بمجرد الاكتفاء بمتابعة المبارزات الرياضية والتعاطف مع أحد الأطراف
السلبي؛ فإنه يستطيع أن يفرغ العنف المحتقن داخله دون خطر بالمقدار الذي
يستطيع به التعاطف أو الاتحاد مع منفذ الحركات العنيفة بشكلها الرياضي. إذ
هو ذاته. وبوسعنا أن نلاحظ بسهولة أن القواعد التي تحكم المبارزات
الرياضية تزداد وتتعقد بالمقدار الذي يزداد فيه عدد المشاركين في الحدث
الرياضي ككل! وهذا ما يسبب بدوره الإحباط والعنف من جديد لأن تلك
القواعد تقيد المتبارزين والمتابعين على حد سواء وتسلبهم حريتهم في التعبير
تجري في عطلة نهاية الأسبوع: فلقد أصبح العنف الفعلي الظاهر بين مشجعي
الفريقين مشهدا مألوفا بعد انتهاء المباريات - وأحيانا أثناءها! وفي الواقع
ليس لدينا أية "لعبة"' رياضية تسمح قواعدها بإظهار العنف بشكل صريح
أو "صمام" أمان للعنف المحتقن في داخلناء ولكنه يبقى مجرد منفذ صغير غير
قادر على احتواء كل العنف المتزايد المحتقن فينا .
وكيف نحكم على مشاهد العنف التي تتسابق أمام أعين المشاهدين على
سبق ذكره في مجال متابعة المباريات والمبارزات الرياضية؛ أن مشاهد
العنف التي يتابعها الإنسان المعاصر على شاشة العرض أو على خشبة
المسرح في أوقات فراغه وأثناء ممارسته لأكثر أنواع الهوايات انتشاراً في
الوقت الراهن من شأنها أن تساهم في خفض مستوى العنف المحتقن لديه من
خلال تعاطفه أو اتحاده مع ممثل تلك المشاهد العنيفة وشعوره بأنه هو من
يؤدي تلك المشاهد! إن الدراسات في هذا المجال تثبت أن هذا الاعتقاد صحيح
ولو ضمن حدود معينة. فمجرد متابعة مشاهد العنف على الشاشة أو على
خشبة المسرح تكفي أحياناً ليصبح بعض الناس أقل استعدادا للقيام بأفعال
العنف عما كانوا عليه قبل المتابعة. ولكن الدراسات تظهر أيضاً أن مشاهد
العنف قد ترفع من استعداد البعض الآخر للقيام بأعمال العنف حتى إن بعض
الشباب على وجه الخصوص يتشجعون على التصرف بعنف مشابه للمشاهد
على الشاشة أو على خشبة المسرح! ولا نملك لسوء الحظ أية إمكانية لتوقع
أثر ما يقدم على شاشة الرائي أو السينما أو على خشبة المسرح على المشاهد
كما إننا لا نستطيع من الناحية السيكولوجية أن نحدد آلية التأثير بدقة. وعلينا
أن نقبل من حيث المبداً بوجود إمكانيات وأشكال متعددة للتأثر .
ولسوء الحظ أيضاً فإن إمكانية التخلص من العنف المحتقن من خلال
القيام بالأعمال الجسدية المرهقة إلى حد ما أثناء ممارسة الهوايات التي تعتمد
على الحركة الجسدية (نحو العناية بحديقة البيت أو ممارسة ركوب الخيل في
الحقول على سبيل المثال) لم تعد متاحة للإنسان المعاصر بشكل عام. وقد
يعود السبب في ذلك إلى ضيق الوقت أو إلى عدم توفر الإمكائيات المادية
ك النشاطات. وإن كانت تلك الإمكانية متوفرة لقلة من الناس»
غير متوفرة على نطاق واسع.
وهناك إمكانية أخرى للتخلص من العنف المحتقن كانت توظف سابقاً
مرة على الأقل في كل جيل ولكنها لم تعد متاحة في عصرنا الراهن لأنها
أصبحت محكمة الإتقانء إنها إمكانية خوض الحرب. ففي الحرب تلغى فجأة
العنف التي يتابعها الإنسان المعاصر على شاشة العرض أو على خشبة
المسرح في أوقات فراغه وأثناء ممارسته لأكثر أنواع الهوايات انتشاراً في
الوقت الراهن من شأنها أن تساهم في خفض مستوى العنف المحتقن لديه من
خلال تعاطفه أو اتحاده مع ممثل تلك المشاهد العنيفة وشعوره بأنه هو من
يؤدي تلك المشاهد! إن الدراسات في هذا المجال تثبت أن هذا الاعتقاد صحيح
ولو ضمن حدود معينة. فمجرد متابعة مشاهد العنف على الشاشة أو على
خشبة المسرح تكفي أحياناً ليصبح بعض الناس أقل استعدادا للقيام بأفعال
العنف عما كانوا عليه قبل المتابعة. ولكن الدراسات تظهر أيضاً أن مشاهد
العنف قد ترفع من استعداد البعض الآخر للقيام بأعمال العنف حتى إن بعض
الشباب على وجه الخصوص يتشجعون على التصرف بعنف مشابه للمشاهد
على الشاشة أو على خشبة المسرح! ولا نملك لسوء الحظ أية إمكانية لتوقع
أثر ما يقدم على شاشة الرائي أو السينما أو على خشبة المسرح على المشاهد
كما إننا لا نستطيع من الناحية السيكولوجية أن نحدد آلية التأثير بدقة. وعلينا
أن نقبل من حيث المبداً بوجود إمكانيات وأشكال متعددة للتأثر .
ولسوء الحظ أيضاً فإن إمكانية التخلص من العنف المحتقن من خلال
القيام بالأعمال الجسدية المرهقة إلى حد ما أثناء ممارسة الهوايات التي تعتمد
على الحركة الجسدية (نحو العناية بحديقة البيت أو ممارسة ركوب الخيل في
الحقول على سبيل المثال) لم تعد متاحة للإنسان المعاصر بشكل عام. وقد
يعود السبب في ذلك إلى ضيق الوقت أو إلى عدم توفر الإمكائيات المادية
ك النشاطات. وإن كانت تلك الإمكانية متوفرة لقلة من الناس»
غير متوفرة على نطاق واسع.
وهناك إمكانية أخرى للتخلص من العنف المحتقن كانت توظف سابقاً
مرة على الأقل في كل جيل ولكنها لم تعد متاحة في عصرنا الراهن لأنها
أصبحت محكمة الإتقانء إنها إمكانية خوض الحرب. ففي الحرب تلغى فجأة
كتابات مشابهة
قواعد السطوة
تُرجم إلى أكثر من 20 لغة ، وقرأه الملايين حول العالم ، وأصبح كالظاهرة في الغرب ؛ ليس فقط لأن الكاتب قد استطاع بإقتدار بمراجعته لسير ونصائح العظماء...
21 يوما للحصول على القوة والسلطة في تعاملك مع الاخرين
يعلمك كتاب21 يوما للحصول على القوة والسلطة في تعاملك مع الاخرين كيف تنمى سلطتك الذاتية وتصبح قادراً على قيادة الآخرين وتولى موقع القيادة و إثبات...
أعداؤك كيف تنتصر عليهم
واقع الأمر أن لكل انسان أصدقاء وأعداء ,وليس من الضرورى أن يعاديك بعض الناس بسبب سوء تصرف بدر منك , أو لأنك شخصية غير ناجحة فى علاقتها الاجتماعية...
التفكير الإيجابى
لقد ساهم كتاب التفكير الإيجابي القيم والأكثر مبيعاً في مد يد العون للآلاف للسيطرة على حياتهم ويساعد أيضاً على وضع برنامج شخصي للنجاح، والذي يعت...
21 قانوناً لا يقبل الجدل فى القيادة
الإدارة .. علم أم خبرة أم موهبة أم فن؟ إنها بالتأكيد علم، ولكنه علم ظل لمدة طويلة لا يلقى الاعتراف به إلا بعد أن يتبلور مع الخبرة؛ فالمؤسسات الك...
نكلم بدون خوف
سيجد القارئ في هذا الكتاب، كل ما يحتاجه كي يصبح محدثاً طلقا، من خلال تنفيذ الخطة المتكاملة التي يقدمها له، والتي تعطيه ولمرة واحدة وأخيرة، الحلول...







