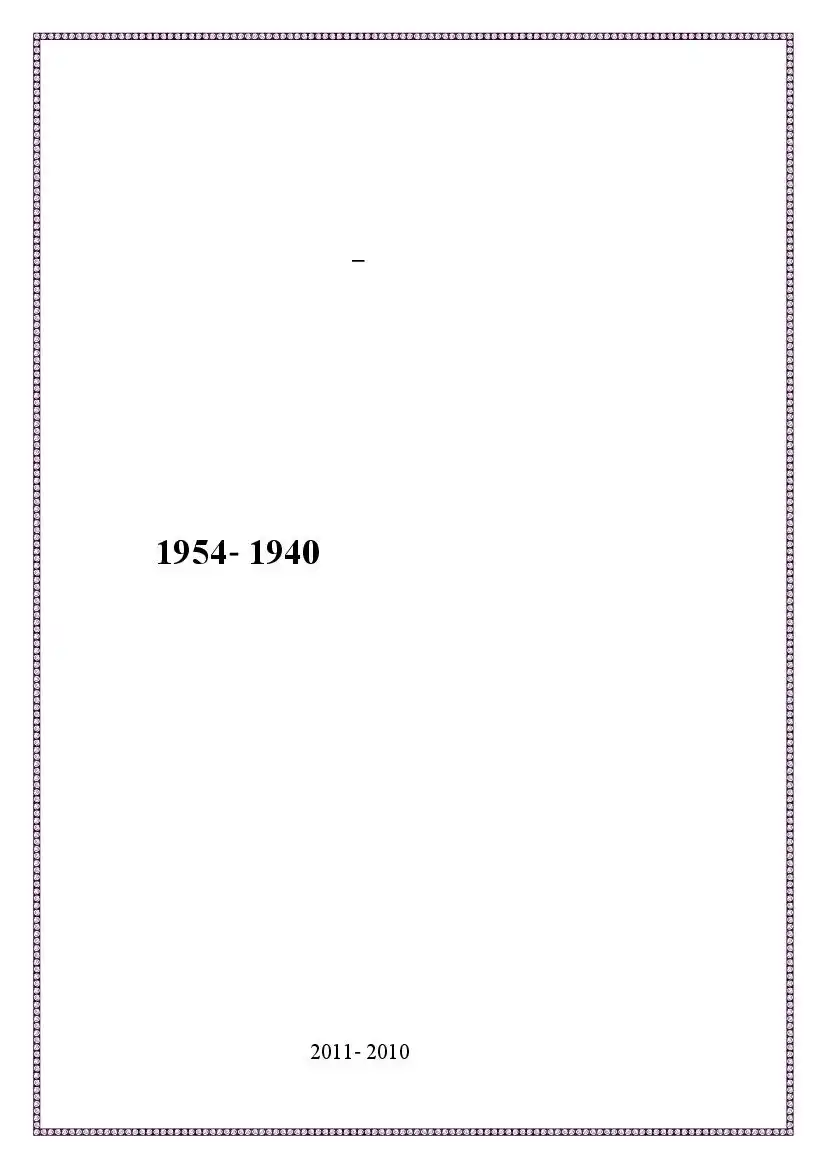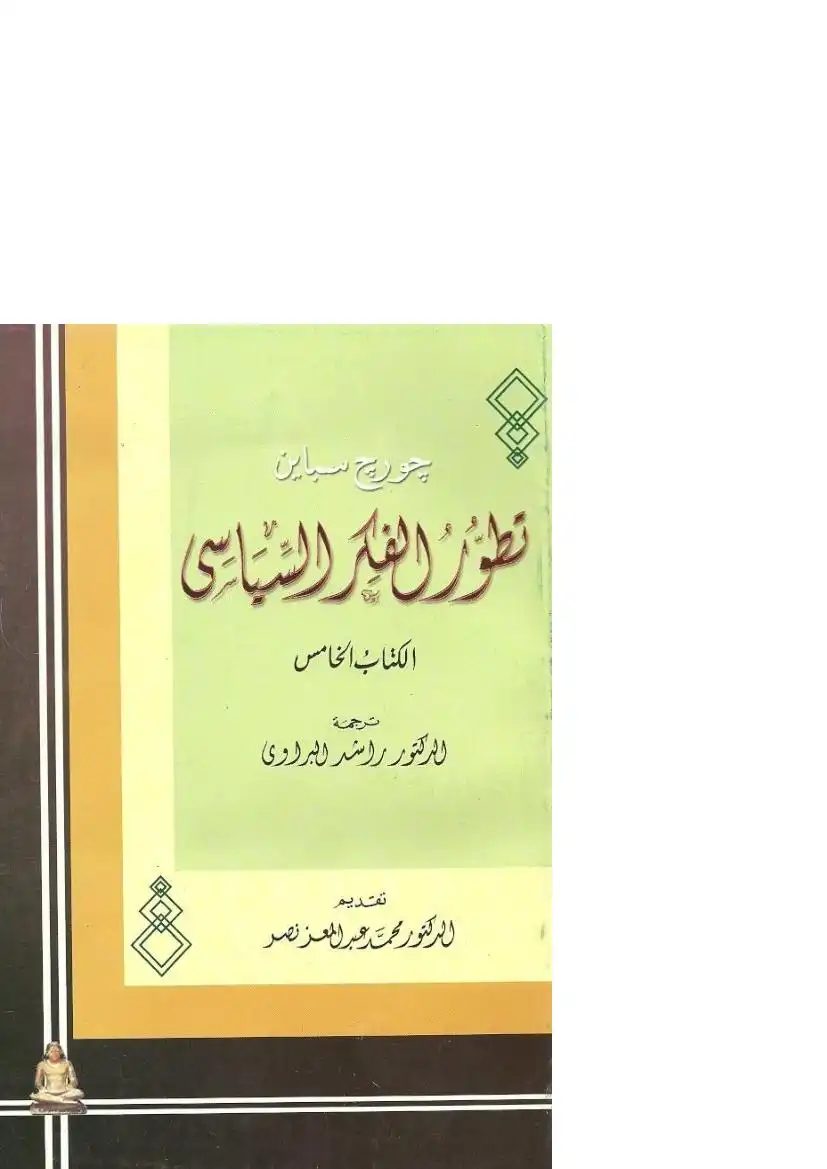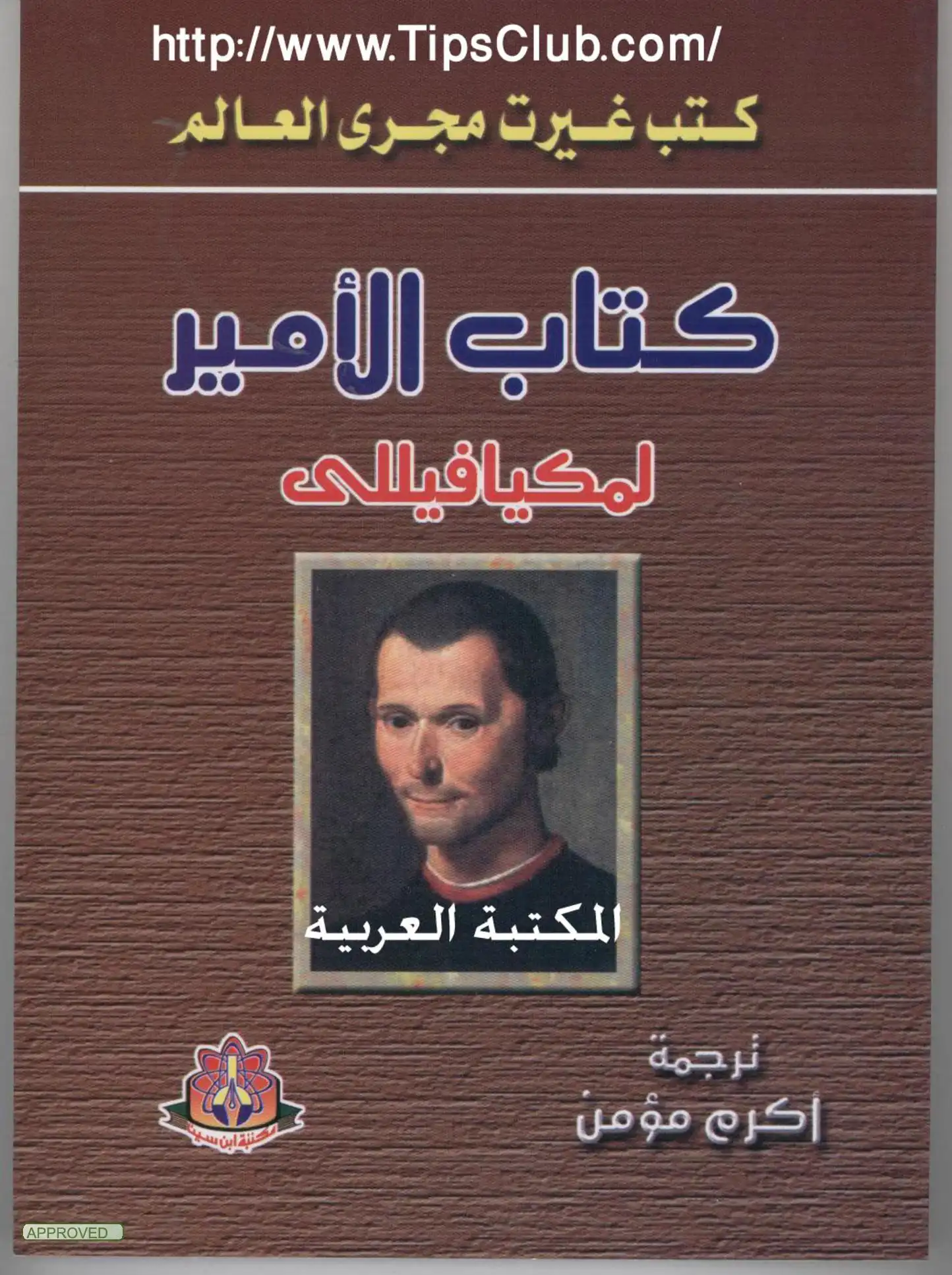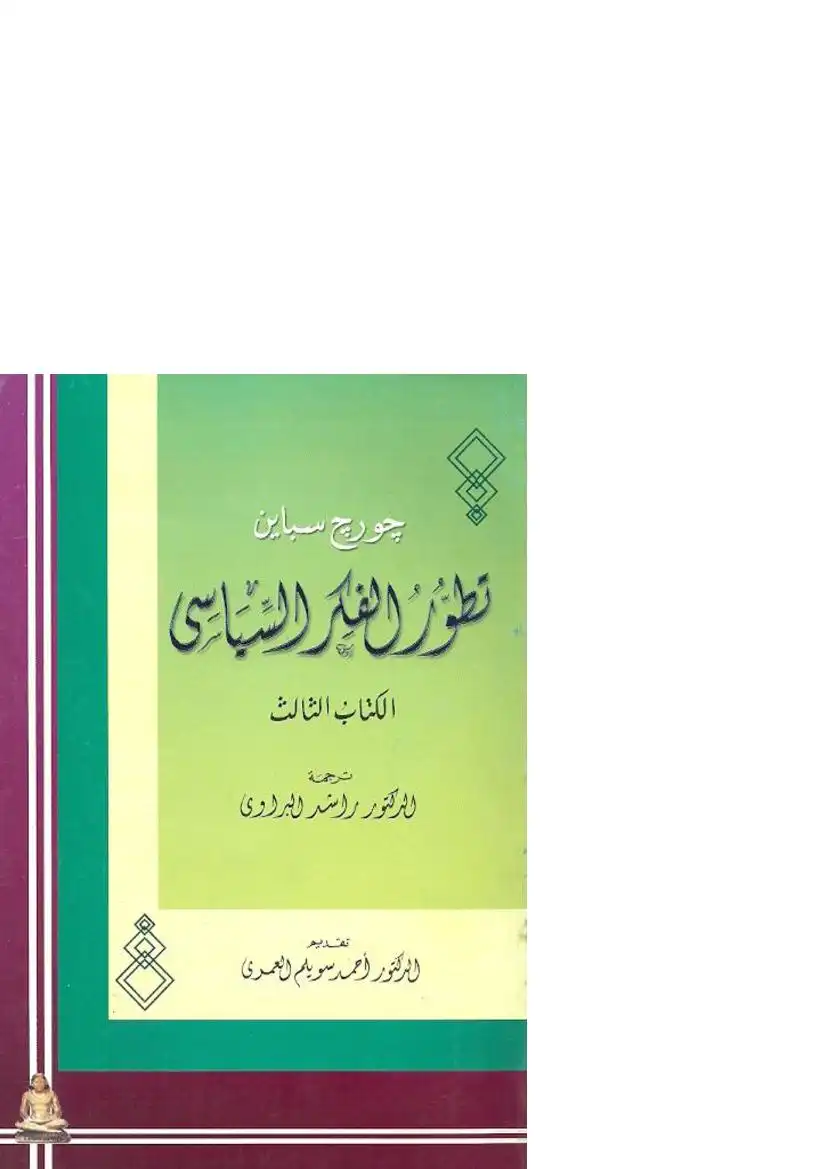المحتويات
تمثيل الشحب
لاد الدكتاتورية
الحكم المطلق في القرن العشرين
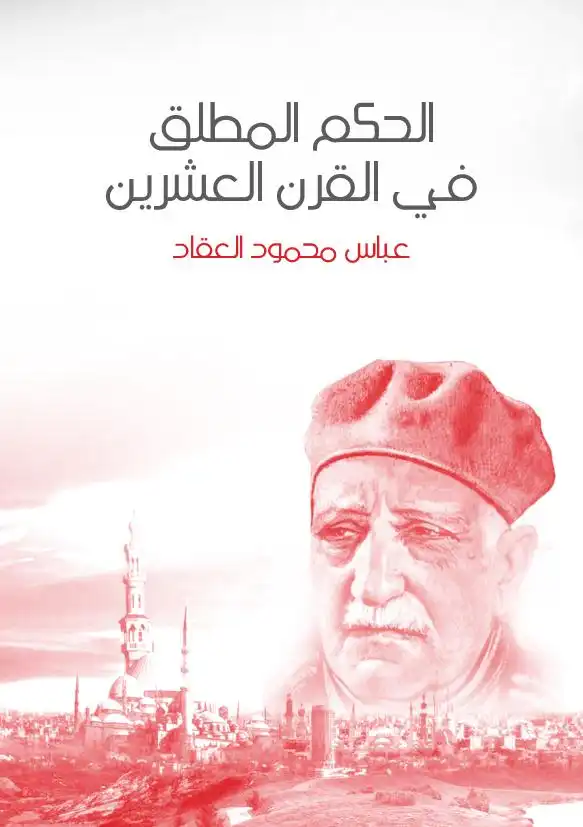
الوصف
كان الاستبداد المطلق مقدسًا في زعم رجال الدين الذين كانوا يستعينون به على حفظ
مكانتهم, وقضاء مآربهم. وكان هو يستعين بهم على تقرير نفوذه؛ وشمول سلطاته على
الضمائر والأجسام؛ وكان لح الحكم مصدر إلهي يتلقاه الحاكم المستبد من السماءء
تخفى عليه كما يؤمن بأسرار حكمة القدر؛ فالحكومة رسالة سماوية معصومة على هذه
السرمدي من رحمة الله
كان هذا هو مصدر الحكومة المستبدة إلى ما قبل القرن الثامن عشر, وكان الإيمان
المجرم جريمته. والآثم وصمة عاره. فلما انتقل سلطان الحكم من الملوك المستبدين إلى
مشيئة الشعوب انتقلت القداسة معه إلى المصدر الجديد. وأصبح حق الحكم مقسًا -
مرة أخرى - من طريق الشعب لا من طريق الصوامع والكهان. وتَغيرِ النظام القديم ولم
قالبه الذي صنعته العادات المتأصلة والمصالح المتشعبة والعقائد الموروثة. وربما
بدأت هذه القداسة الشعبية على سبيل المجاز في التعبير, يلجأ إليه دعاة النظام الحديث
للمقابلة بين أساس الحكومة الغابرة وأساس الحكومة الحاضرة. ثم أ إلى هذا
المجاز حماسة الفكرة الناشئة. وروح الأمل في الستقبل. والنقمة على الماضي. فأصبحت
القداسة الحديثة عقيدة في الضمير يشوبها من الإبهام كل ما يشوب العقائد التي تستعمي
أصبحت الديمقراطية عقيدة مقدّسة في العرف الشائع. فجاءها الخطر من هذه
مكانتهم, وقضاء مآربهم. وكان هو يستعين بهم على تقرير نفوذه؛ وشمول سلطاته على
الضمائر والأجسام؛ وكان لح الحكم مصدر إلهي يتلقاه الحاكم المستبد من السماءء
تخفى عليه كما يؤمن بأسرار حكمة القدر؛ فالحكومة رسالة سماوية معصومة على هذه
السرمدي من رحمة الله
كان هذا هو مصدر الحكومة المستبدة إلى ما قبل القرن الثامن عشر, وكان الإيمان
المجرم جريمته. والآثم وصمة عاره. فلما انتقل سلطان الحكم من الملوك المستبدين إلى
مشيئة الشعوب انتقلت القداسة معه إلى المصدر الجديد. وأصبح حق الحكم مقسًا -
مرة أخرى - من طريق الشعب لا من طريق الصوامع والكهان. وتَغيرِ النظام القديم ولم
قالبه الذي صنعته العادات المتأصلة والمصالح المتشعبة والعقائد الموروثة. وربما
بدأت هذه القداسة الشعبية على سبيل المجاز في التعبير, يلجأ إليه دعاة النظام الحديث
للمقابلة بين أساس الحكومة الغابرة وأساس الحكومة الحاضرة. ثم أ إلى هذا
المجاز حماسة الفكرة الناشئة. وروح الأمل في الستقبل. والنقمة على الماضي. فأصبحت
القداسة الحديثة عقيدة في الضمير يشوبها من الإبهام كل ما يشوب العقائد التي تستعمي
أصبحت الديمقراطية عقيدة مقدّسة في العرف الشائع. فجاءها الخطر من هذه
الحكم المطلق في القن العشرين
وقدرة التصغير والتقييد. فأسرعوا إليه في جد ووقار. وأ.
الديمقراطية شيء لم يهبط على الأرض من السماء؛ وإن القداسة هنا مجازٌ لا حقيا
العلم والاستقراء. فكان الجاحدون لقداسة الديمقراطية والمؤمتون بتلك القداسة المنزّهة
عن الشوائب بمنزلة واحدة من الفهم والسداد؛ لأن قداسة الديمقراطية لم تكن مسألة
علمية يبحثها الناقدون المحصون على هذا الاعتبار من جانب القبول أو من جانب الإنكار»
والجهلاء؛ ولا ينظرون إليها من أوسع الحدود التي يحيط بها مَن يعرف حقيقتهاء
ويقيسها بمقياسها الصحيح. وإذا كان المتكلم الذي الماء العذب شهد حلو
المذاق مخطنًا في صيغة التعبير العلمي. فأشد منه إمعانًا في الخطأ والغفلة عن الحقيقة
من يحمل الماء العذب إلى العمل الكيمي؛ ليثبت أن الماء ماء؛ وليس بشهد حلو المذاق كما
يقولون في لغة المجاز.
الاشتغال بتطبيقه على الأفراد والشعوب؛ ولعل أغرب ما استغربه الناس من قضايا هذا
العلم وصفه لأطوار الجماعات والأساليب التي يَجِرِي عليها في تكوين عقائدهاء وتوجيه
أهوائهاء وتسيير حركاتهاء وإثارة خواطرهاء فقد جاء هذا الوصف بعد شيوع الديمقراطية
في العالم الحديث بأكثر من جيلين. فلاح لمعظم الناس كأنه غريب. وكأنه مخالف للمقرر
تَقدم في عصر الإصلاح مثلًا لما وقع من الأفكار موقع الغرابة في شيء. ولا أحاط به ذلك
السحر الذي يحيط بكل هجمة مخالفة للمألوف. ثم لجأت الديمقراطية حتمًا في سياقها
الطبيعي دون أن يحَيِّل إلى أحد أن حقائق علم الن رض الحكم الديمقراطي أو
تعارض حكم الشعوب؛ لأن الديمقراطية كانت نتيجة لازمة لفساد حكم الاستبداده ولم
تكن نتيجة لجهل الناس بالسيكولوجية وخطتهم في تفسير حركات الجماعات؛ فلو عَم
الناس في القرن الرابع عشر أو الخامس عشر أن حركات الشعوب غير مقدّسة؛ ولا منزّهة
للأنظمة العتيقة من التداعي والسقوط؛ ولكن «السيكولوجية» ظهرت بعد الديمقراطية.
فنشأت غرابتها من كم؛ وكان استغراب الناس إياها وهمًا متولدًا من الوهم القديم الذي
وقدرة التصغير والتقييد. فأسرعوا إليه في جد ووقار. وأ.
الديمقراطية شيء لم يهبط على الأرض من السماء؛ وإن القداسة هنا مجازٌ لا حقيا
العلم والاستقراء. فكان الجاحدون لقداسة الديمقراطية والمؤمتون بتلك القداسة المنزّهة
عن الشوائب بمنزلة واحدة من الفهم والسداد؛ لأن قداسة الديمقراطية لم تكن مسألة
علمية يبحثها الناقدون المحصون على هذا الاعتبار من جانب القبول أو من جانب الإنكار»
والجهلاء؛ ولا ينظرون إليها من أوسع الحدود التي يحيط بها مَن يعرف حقيقتهاء
ويقيسها بمقياسها الصحيح. وإذا كان المتكلم الذي الماء العذب شهد حلو
المذاق مخطنًا في صيغة التعبير العلمي. فأشد منه إمعانًا في الخطأ والغفلة عن الحقيقة
من يحمل الماء العذب إلى العمل الكيمي؛ ليثبت أن الماء ماء؛ وليس بشهد حلو المذاق كما
يقولون في لغة المجاز.
الاشتغال بتطبيقه على الأفراد والشعوب؛ ولعل أغرب ما استغربه الناس من قضايا هذا
العلم وصفه لأطوار الجماعات والأساليب التي يَجِرِي عليها في تكوين عقائدهاء وتوجيه
أهوائهاء وتسيير حركاتهاء وإثارة خواطرهاء فقد جاء هذا الوصف بعد شيوع الديمقراطية
في العالم الحديث بأكثر من جيلين. فلاح لمعظم الناس كأنه غريب. وكأنه مخالف للمقرر
تَقدم في عصر الإصلاح مثلًا لما وقع من الأفكار موقع الغرابة في شيء. ولا أحاط به ذلك
السحر الذي يحيط بكل هجمة مخالفة للمألوف. ثم لجأت الديمقراطية حتمًا في سياقها
الطبيعي دون أن يحَيِّل إلى أحد أن حقائق علم الن رض الحكم الديمقراطي أو
تعارض حكم الشعوب؛ لأن الديمقراطية كانت نتيجة لازمة لفساد حكم الاستبداده ولم
تكن نتيجة لجهل الناس بالسيكولوجية وخطتهم في تفسير حركات الجماعات؛ فلو عَم
الناس في القرن الرابع عشر أو الخامس عشر أن حركات الشعوب غير مقدّسة؛ ولا منزّهة
للأنظمة العتيقة من التداعي والسقوط؛ ولكن «السيكولوجية» ظهرت بعد الديمقراطية.
فنشأت غرابتها من كم؛ وكان استغراب الناس إياها وهمًا متولدًا من الوهم القديم الذي
تطرَّق إليهم من تقديس الشعب بعد تقديس العواهل المستبدين. فلولا الخرافة الداثرة؛
الناس من أطوار الأفراد أنهم يطمعون ويستأثرون. وأنهم ينقادون للهوى. ويَخضعون
للشهوات. وأنهم عرضة للخطأ الكثير والضلال البعيدء وأنهم غير معصومين بحال» فلم
يكن هذا العلم بأطوار الأفراد هو الذي قضى على حكومة الفرد. ولم تتقوض النظم الأولى
إلا حين تعذر التوفيق بينها وبين أحوال الرعايا ومطالب الأمم.
لم تنقض عل الديمقراطية ستوات حتى خيبت آمال الحالمين فيهاء وخيبت آمال أولئك
المظلومين الذين صوروا زمانها الترقب في صورة الفردوس الأرضيء أو العصر الذهبي
الذي تغنى به الشعراء. وتحدثت به الأساطير, قلا ظلم ولا إجحاف ولا ت: القوي
والضعيف أو القريب والبعيد: كأنما صوت الشعب المنطلق من غيابات الأسر تغمة ساحرة
هذا منتظرًا من الديمقراطية فلا جرم يخيب فيها الظن. ويحكم عليها الحاكمون بالفشل
بعد أول صدمة مع وقائع الحياة. وعثرات التجربة الأولى. وهي لا تخلو من ١
تسلم من الاضطراب؛ فلم يكن أقسى على الديمقراطية ولا أظلم لها من غلاة المؤمتين بها
الديمقراطي. والأخذ فيه بالعرض دون الجوهر القصود؛ على أنها ليست بجميع الأسباب
الشعب قلما تتجاوز العرضيات إلى دخائل الأمورء قمتها أن عيوب الحكومة الشعبية
التكشف أن يغض من فضائلها بعض الثيء؛ ويرسل عليها ألسنة الثراثرة والفضوليين
الناس من أطوار الأفراد أنهم يطمعون ويستأثرون. وأنهم ينقادون للهوى. ويَخضعون
للشهوات. وأنهم عرضة للخطأ الكثير والضلال البعيدء وأنهم غير معصومين بحال» فلم
يكن هذا العلم بأطوار الأفراد هو الذي قضى على حكومة الفرد. ولم تتقوض النظم الأولى
إلا حين تعذر التوفيق بينها وبين أحوال الرعايا ومطالب الأمم.
لم تنقض عل الديمقراطية ستوات حتى خيبت آمال الحالمين فيهاء وخيبت آمال أولئك
المظلومين الذين صوروا زمانها الترقب في صورة الفردوس الأرضيء أو العصر الذهبي
الذي تغنى به الشعراء. وتحدثت به الأساطير, قلا ظلم ولا إجحاف ولا ت: القوي
والضعيف أو القريب والبعيد: كأنما صوت الشعب المنطلق من غيابات الأسر تغمة ساحرة
هذا منتظرًا من الديمقراطية فلا جرم يخيب فيها الظن. ويحكم عليها الحاكمون بالفشل
بعد أول صدمة مع وقائع الحياة. وعثرات التجربة الأولى. وهي لا تخلو من ١
تسلم من الاضطراب؛ فلم يكن أقسى على الديمقراطية ولا أظلم لها من غلاة المؤمتين بها
الديمقراطي. والأخذ فيه بالعرض دون الجوهر القصود؛ على أنها ليست بجميع الأسباب
الشعب قلما تتجاوز العرضيات إلى دخائل الأمورء قمتها أن عيوب الحكومة الشعبية
التكشف أن يغض من فضائلها بعض الثيء؛ ويرسل عليها ألسنة الثراثرة والفضوليين
الحكم المطلق في القرن العشرين
ومن الأسباب المصطنعة أن نقد الديمقراطية يرضي غرور تلك الفئة التي تحب أن
تتعالى عن «الشعبيات»؛ ما في ذلك من الامتياز والادعاء, ومنها أن المستبدين الطامعين في
رجعة الحكم القديم يسعون سعيهم سرًا وجهرًا لتشويه كل نظام غير نظامهم وتأليب
تتوالى فيه المخترّعات. ويسألون فيه أبدًا عن أحدث الآراء. وأغرب الأخبار, فإذا مضت
يُعدم له سامعين بين طلاب الزي الطريف في كل مجالء
أن نقد الديمقراٌ يصادف من العناية أضعاف ما تستوجبه الأسباب
الحقيقية التي لا دخل فيها للوهم والغرض والفضول. وأما الأسباب المصطنعة؛ فما هي؟
ومن الأسباب المصطنعة أن نقد الديمقراطية يرضي غرور تلك الفئة التي تحب أن
تتعالى عن «الشعبيات»؛ ما في ذلك من الامتياز والادعاء, ومنها أن المستبدين الطامعين في
رجعة الحكم القديم يسعون سعيهم سرًا وجهرًا لتشويه كل نظام غير نظامهم وتأليب
تتوالى فيه المخترّعات. ويسألون فيه أبدًا عن أحدث الآراء. وأغرب الأخبار, فإذا مضت
يُعدم له سامعين بين طلاب الزي الطريف في كل مجالء
أن نقد الديمقراٌ يصادف من العناية أضعاف ما تستوجبه الأسباب
الحقيقية التي لا دخل فيها للوهم والغرض والفضول. وأما الأسباب المصطنعة؛ فما هي؟
لم تفشل الديمقراطية
وثباتهاء وأنها ستكون أساسًا للحكم في المستقبل تُبنى عليه قواعد الحكومات. ويُرجع
إليه في إصلاح كل ما يحتاج منها إلى الإصلاح»
أما تلك الأسباب المصطنعة التي ألمنا بهاء فأكثر مَن يتعلق بهاء ويعمل لترويجها
هم أنصار الحكم المطلق والرجعة إلى الاستبداد القديم؛ وهم أقل الناس قا في تجريح
الديمقراطية. بعدما تبي من فشل حكمهم في بلاد كثيرة وأحوال مختلفة. فإذا بطل إيمان
الناس بقداسة الديمقراطية - مجارًا أو حنَّا - فمن المقرر المقطوع به أنهم لا يرجعون
إلى الإيمان بقداسة المستبدين وما يزيفونه من الدعاوى والجهالات.
شأنها ضعيقًا في تصريف الأمم وقيادة الحكومات. وماذا كان يصنع المستبدون طوال
بالمظاهر والوجاهات والألقاب والأسماء, وتارة أخرى بالعطايا والمواعيد. إلى سائر ماهو
معروف من أساليبهم في تمويه الأعمال: وإخفاء الحقائق. والتحيل على الغرائز والشهوات.
ولو أحصيت الحروب التي أريقت فيها دماء الألوف من المحاريين والسامين لخداع
الشعوب وتمليقها أو لو أحصيت الأرواح البريئة التي أزهقها أعداء الحرية والمعرفة. أو
لي أسبيت الثورات والقلاقل التي شجرت بين الحكام والرعايا من أجل المظاهر والأسماء
والمنازعات الصبيانية والدعاوى الفارغة. أو لو أحصيت الدسائس والجرائم التي انغمس
فيها طلاب الحظوة وأعوان الطغيان لكان في بعض ذلك شاهد على حقيقة مَنَ تنقعهم
وثباتهاء وأنها ستكون أساسًا للحكم في المستقبل تُبنى عليه قواعد الحكومات. ويُرجع
إليه في إصلاح كل ما يحتاج منها إلى الإصلاح»
أما تلك الأسباب المصطنعة التي ألمنا بهاء فأكثر مَن يتعلق بهاء ويعمل لترويجها
هم أنصار الحكم المطلق والرجعة إلى الاستبداد القديم؛ وهم أقل الناس قا في تجريح
الديمقراطية. بعدما تبي من فشل حكمهم في بلاد كثيرة وأحوال مختلفة. فإذا بطل إيمان
الناس بقداسة الديمقراطية - مجارًا أو حنَّا - فمن المقرر المقطوع به أنهم لا يرجعون
إلى الإيمان بقداسة المستبدين وما يزيفونه من الدعاوى والجهالات.
شأنها ضعيقًا في تصريف الأمم وقيادة الحكومات. وماذا كان يصنع المستبدون طوال
بالمظاهر والوجاهات والألقاب والأسماء, وتارة أخرى بالعطايا والمواعيد. إلى سائر ماهو
معروف من أساليبهم في تمويه الأعمال: وإخفاء الحقائق. والتحيل على الغرائز والشهوات.
ولو أحصيت الحروب التي أريقت فيها دماء الألوف من المحاريين والسامين لخداع
الشعوب وتمليقها أو لو أحصيت الأرواح البريئة التي أزهقها أعداء الحرية والمعرفة. أو
لي أسبيت الثورات والقلاقل التي شجرت بين الحكام والرعايا من أجل المظاهر والأسماء
والمنازعات الصبيانية والدعاوى الفارغة. أو لو أحصيت الدسائس والجرائم التي انغمس
فيها طلاب الحظوة وأعوان الطغيان لكان في بعض ذلك شاهد على حقيقة مَنَ تنقعهم
الحكم المطلق في القن العشرين
وإنما الفرق بين الاستبداد والديمقراطية أن المجال يتسع في هذه لأقوال شتى ت:
الحقيقة من بينهاء ولكنه لا يتسع في عهد الاستبداد لكل قائلء ولا يصعب فيه التواطق
وإن مجرد القول: بأن الشعوب لا تصلح للديمقراطية دليل على أنها درجة عالية
يجب أن تتوجه إليها آمال الصلحين وطلاب الكمالء في حين أن القول بجهل الشعوب
واضطرارها من أجل ذلك إلى الحكم المطلق دليل على مصلحة الحكام المطلّقين في بقاء
ومما يُضعف جانب الحكام المطلقين في دعوتهم هذه أنهم يعيبون على الجماهير
الصالحين هم رجال الشعوب. وثمرة تلك الأطوار. وأن الجماهير لا تنقصها البديهة التي
تفطن بها إلى مقدرة القادة. وتوليهم إعجابهاء وتخصهم بثقتها وإقبالهاء وتسلمهم
زمامها حتى ئون على عاداتها التي تغار عليها وتغضب للمساس بها إذا مسها
إصلاحه. فليس أقدر على هذا للطلب من زعيم شعبي تبرزه البديهة الشعبية. ولا أسرع
منه في حث غريزة الأمم؛ ومغالبة ما فيها من العيوب. وكأن هذا المصلح هو الزوج الحبوب
الذي يطاع لأن طاعته سرور؛ ويقاس مقدار حبه بمقدار المشقة التي تُبذل في إطاعة أمرة.
وهي هي الأطوار التي لازمتها في كل ما تمخضت عنه الإنسانية من الثقافات. وفي كل من
تمخضت عنهم من الدعاة والصلحين. فأصلَحٌ الطبائع لإحياء الشعوب هي الطبائع التي
بينها وبين الشعوب مجاوبة في الشعور. ومساجلة في عناصر الحياة, وإذا كانت الشعوب
تخطئ في عرف العلماء. فليس عرف العلماء هنا هو المقياس الذي يُرجع إليه في تقدير
الدوافع والنتائج؛ لأن الطبيعة لا تستشير العلماء فيما تعمل وفيما تريد. بل ليس العلماء
وإنما الفرق بين الاستبداد والديمقراطية أن المجال يتسع في هذه لأقوال شتى ت:
الحقيقة من بينهاء ولكنه لا يتسع في عهد الاستبداد لكل قائلء ولا يصعب فيه التواطق
وإن مجرد القول: بأن الشعوب لا تصلح للديمقراطية دليل على أنها درجة عالية
يجب أن تتوجه إليها آمال الصلحين وطلاب الكمالء في حين أن القول بجهل الشعوب
واضطرارها من أجل ذلك إلى الحكم المطلق دليل على مصلحة الحكام المطلّقين في بقاء
ومما يُضعف جانب الحكام المطلقين في دعوتهم هذه أنهم يعيبون على الجماهير
الصالحين هم رجال الشعوب. وثمرة تلك الأطوار. وأن الجماهير لا تنقصها البديهة التي
تفطن بها إلى مقدرة القادة. وتوليهم إعجابهاء وتخصهم بثقتها وإقبالهاء وتسلمهم
زمامها حتى ئون على عاداتها التي تغار عليها وتغضب للمساس بها إذا مسها
إصلاحه. فليس أقدر على هذا للطلب من زعيم شعبي تبرزه البديهة الشعبية. ولا أسرع
منه في حث غريزة الأمم؛ ومغالبة ما فيها من العيوب. وكأن هذا المصلح هو الزوج الحبوب
الذي يطاع لأن طاعته سرور؛ ويقاس مقدار حبه بمقدار المشقة التي تُبذل في إطاعة أمرة.
وهي هي الأطوار التي لازمتها في كل ما تمخضت عنه الإنسانية من الثقافات. وفي كل من
تمخضت عنهم من الدعاة والصلحين. فأصلَحٌ الطبائع لإحياء الشعوب هي الطبائع التي
بينها وبين الشعوب مجاوبة في الشعور. ومساجلة في عناصر الحياة, وإذا كانت الشعوب
تخطئ في عرف العلماء. فليس عرف العلماء هنا هو المقياس الذي يُرجع إليه في تقدير
الدوافع والنتائج؛ لأن الطبيعة لا تستشير العلماء فيما تعمل وفيما تريد. بل ليس العلماء
لم تفشل الديمقراطية
أنفسهم بنجوة من الخطأ على حسب مقياسهم؛ لأن أخطاءهم - قديمًا وحديًا - في
تصور الحكومات النافعة أكثر وأكبر من أخطاء الشعوب كلها مجتمعات.
وللديمقراطية عيوبهاء ولكنها عيوب الطبيعة الإنسانية التي لا فكاك منهاء وقد
يكون لهذه العيوب في مجموع الحضارات الإنسانية فضل كفضل المحاسن الصطلح
عليها إن لم يزد عليه. ولا تقارّن الديمقراطية بحكومة المثل الأعلى المنشودة في الخيال»
ولكنها تقارّن بالأنظمة الأخرى في جملتهاء ويُنظر في عيوبها بصدق وإخلاص وتقدير
طارئة يزيلها المزيد من الديمقراطية؛ إذ كان من المحقق أن محاربة الديمقراطية لم تُزلها
للعصبيات الحزبية مخرجًا غير الفتن الدموية, وأقنعت الشعوب بأن عليها تبعة في الحكم؛
وأنها قادرة على تبديل الحكام؛ فضعفت فيها نزعة الثورة ب اك في
الحكومة. والقدرة على تبديلهاء وهي في مدى خمسين سنة قد صاحبت في عالم الصناعة
والعلم تقدمًا لم تبلغه الإنسانية في لصي ألف سنة. وكلما ازداد هذا التقدم صعب على
بعده ملك السيد للعبيد. .|
يقول بعض الباحثين - ومنهم الأستاذ ساروليا الذي ألقى محاضراته في هذا الموضوع
على طلبة الجامعة المصرية: إن الحكم النيابي تراث إنجليزي غير قابل للتحميم في الأمم
لاختلاف الأحزاب وصعوبة التوفيق بينها إلى زمن طويل. ويُعتبر ذلك الاختلاف من
في هذا للعنى» وكانت فيه حجة من بعض الوجوه على الحكومة التيابية, ولكن الواقع
أن العصبيات الحزبية لم تفتاً تمزق فرنسا كل ممزق في عهود حكامها الطلّقينء ولم
أنفسهم بنجوة من الخطأ على حسب مقياسهم؛ لأن أخطاءهم - قديمًا وحديًا - في
تصور الحكومات النافعة أكثر وأكبر من أخطاء الشعوب كلها مجتمعات.
وللديمقراطية عيوبهاء ولكنها عيوب الطبيعة الإنسانية التي لا فكاك منهاء وقد
يكون لهذه العيوب في مجموع الحضارات الإنسانية فضل كفضل المحاسن الصطلح
عليها إن لم يزد عليه. ولا تقارّن الديمقراطية بحكومة المثل الأعلى المنشودة في الخيال»
ولكنها تقارّن بالأنظمة الأخرى في جملتهاء ويُنظر في عيوبها بصدق وإخلاص وتقدير
طارئة يزيلها المزيد من الديمقراطية؛ إذ كان من المحقق أن محاربة الديمقراطية لم تُزلها
للعصبيات الحزبية مخرجًا غير الفتن الدموية, وأقنعت الشعوب بأن عليها تبعة في الحكم؛
وأنها قادرة على تبديل الحكام؛ فضعفت فيها نزعة الثورة ب اك في
الحكومة. والقدرة على تبديلهاء وهي في مدى خمسين سنة قد صاحبت في عالم الصناعة
والعلم تقدمًا لم تبلغه الإنسانية في لصي ألف سنة. وكلما ازداد هذا التقدم صعب على
بعده ملك السيد للعبيد. .|
يقول بعض الباحثين - ومنهم الأستاذ ساروليا الذي ألقى محاضراته في هذا الموضوع
على طلبة الجامعة المصرية: إن الحكم النيابي تراث إنجليزي غير قابل للتحميم في الأمم
لاختلاف الأحزاب وصعوبة التوفيق بينها إلى زمن طويل. ويُعتبر ذلك الاختلاف من
في هذا للعنى» وكانت فيه حجة من بعض الوجوه على الحكومة التيابية, ولكن الواقع
أن العصبيات الحزبية لم تفتاً تمزق فرنسا كل ممزق في عهود حكامها الطلّقينء ولم
الحكم المطلق في القرن العشرين
أو فتنة على القحط والإفلاس. أو التاج والنبلاء. أو حروب تثار لإخفاء هذه
وسكتت الثورات, وبطلت المجاعات. ولم يمتعها اختلاف الأحزاب أن تتماسك بعد الحرب
وكان نصيبهن من التماسك بعد الحرب على قدر نصيبهن من الحرية والمشاركة في الشئون
عند الخلاف على تقسيم الدوائر الانتخابية وتعديل شروط الانتخاب. وهو في جوهره أشد
من الخلاف الذي أفضى إلى الثورة الجائحة في عهد الاستبدادء
المشهور في الأثريات المصرية - أن الحكومة الشعبية كانت هي الدور الأخير من أدوار
يُضعف الفاتح العظيم فيتازعه الحكم أفراد القادة الغالبون. ثم يَضعف القادة ويستسلم
أبناؤهم للترف والصغائر, فتثور عليهم العامة. وتتولى الأمر الحكومة الشعبية. ثم يسطو
عليهم مغير جديد. فيبد أ الدور الأول كرة أخرى. وهكذا دواليك عصرًا بعد عصر في سجلات
اليوم؛ لأن الحكومة الشعبية كانت في التاريخ القديم فترة منفردة تقع في إحدى الدول. ثم
لا تكون الدول المحيطة بها مجارية لها في تلك الفترة؛ بل رما كانت في بداية الدور الأول
- دور الفاتح العظيم -- فتحدّث الغارات من كَمّ وتتجدد الأدوار. أما اليوم فالحكومة
الشعبية حركة عامة. ومبداً مشترك. وليس بالفترة المنفردة ولا بالدور المقصور على بعض
على أننا إذا قدّرنا أن السنة القديمة تتكرر اليوم كما تكررت في دولات الفراعنة
وجيرانهم. فكل ما يُستخرج من هذه النظرية أن الحكم قد تعذِّر على الطغاة والقادة
أو فتنة على القحط والإفلاس. أو التاج والنبلاء. أو حروب تثار لإخفاء هذه
وسكتت الثورات, وبطلت المجاعات. ولم يمتعها اختلاف الأحزاب أن تتماسك بعد الحرب
وكان نصيبهن من التماسك بعد الحرب على قدر نصيبهن من الحرية والمشاركة في الشئون
عند الخلاف على تقسيم الدوائر الانتخابية وتعديل شروط الانتخاب. وهو في جوهره أشد
من الخلاف الذي أفضى إلى الثورة الجائحة في عهد الاستبدادء
المشهور في الأثريات المصرية - أن الحكومة الشعبية كانت هي الدور الأخير من أدوار
يُضعف الفاتح العظيم فيتازعه الحكم أفراد القادة الغالبون. ثم يَضعف القادة ويستسلم
أبناؤهم للترف والصغائر, فتثور عليهم العامة. وتتولى الأمر الحكومة الشعبية. ثم يسطو
عليهم مغير جديد. فيبد أ الدور الأول كرة أخرى. وهكذا دواليك عصرًا بعد عصر في سجلات
اليوم؛ لأن الحكومة الشعبية كانت في التاريخ القديم فترة منفردة تقع في إحدى الدول. ثم
لا تكون الدول المحيطة بها مجارية لها في تلك الفترة؛ بل رما كانت في بداية الدور الأول
- دور الفاتح العظيم -- فتحدّث الغارات من كَمّ وتتجدد الأدوار. أما اليوم فالحكومة
الشعبية حركة عامة. ومبداً مشترك. وليس بالفترة المنفردة ولا بالدور المقصور على بعض
على أننا إذا قدّرنا أن السنة القديمة تتكرر اليوم كما تكررت في دولات الفراعنة
وجيرانهم. فكل ما يُستخرج من هذه النظرية أن الحكم قد تعذِّر على الطغاة والقادة
كتابات مشابهة